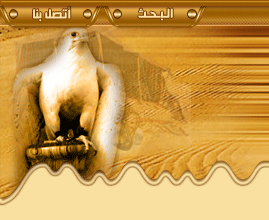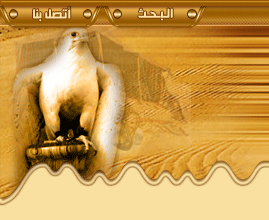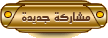السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفاءً بما وعدتكم به سابقاً بالرجوع إلى المعاجم اللغوية.
وكما تناقشنا سابقاً في كتابة - الغلباء - أو الغلبا - بدون همز وكان هناك آراء متضاربة حول هذه الكلمة وقد كان لي رأي في هذا الموضوع قد أدليت به سابقاً وهو الرأي الذي تبادر _ حقيقة _ إلى ذهني أول وهلة ولكني فوجئت برأي أحد الأخوة قد نقله من أحد المواقع الإلكترونية كان يقول بهمزها, مما أثارني حقيقة وقد عدت إلى المعاجم اللغوية وحاولت أن آتي بأكثر قدر ممكن من المعاجم ولم يتيسر لي سوى ثمانية معاجم بعضها في مكتبتي وبعضها أخذته من الجامعة التي انتسب إليها .
والمعاجم التي عدت إليها هي:
1- أساس البلاغة مؤلفه هو محمود الزمخشري
2- الصحاح مؤلفه هو إسماعيل الجوهري
3- العين مؤلفه هو الخليل بن أحمد الفراهيدي
4- المحكم والمحيط الأعظم مؤلفه هو علي بن سيدة
5- المحيط في اللغة ومؤلفه هو الصاحب بن عباد
6- تاج العروس من جواهر القاموس ومؤلفه هو الزبيدي
7- تهذيب اللغة مؤلفه هو محمد الأزهري
8- لسان العرب ومؤلفه ابن منظور
وإليكم ما قالوه هولا العلماء في تفريعات الجذر غلب وتقليباته واشتقاقاته
1-أساس البلاغة
غلب
بينهما غلابٌ أي مغالبة، وتغالبوا على البلد. وغلبته على الشيء: أخذته منه، وهو
مغلوب عليه، وأيغلب أحدكم أن يصاحب الناس معروفاً بمعنى أيعجز. وهو رجل حرّ
وقد أبى أفنغلبه على نفسه: أفنكرهه. وشاعر مغلّب: غلب كثيراً أو غلّب فهو ذم
ومدح. قال امرؤ القيس:
فإنك لم يفخر عليك كعاجز ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب
ومن المجاز: هضبة غلباء، وعزّة غلباء.
واغلولب العشب، "وحدائق غلباً".
2-الصحاح
غلب
غَلَبَهُ غَلَبَةً وغَلْباً، وغَلَباً أيضاً. قال الله تعالى: "وهم من بعدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبون". وغالَبَهُ
مغالبَةً وغِلاباً. وتغلَّب على بلد كذا: استولى عليه قهراً وغَلَّبته أنا عليه تغليباً. والغلاّب:
الكثير الغَلَبَة. والمغلَّب: المغلوب مراراً. والمغلَّب أيضاً من الشعراء: المحكوم عليه بالغَلَبَة
على قِرْنِهِ، كأنَّه غُلِّب عليه، وهو من الأضداد. وتقول: رجلٌ أغْلَبُ بيِّن الغَلَبِ، إذا كان
غليظ الرقبة. وهضبةٌ غَلْباء، وغِرَّةٌ غَلْباء. وحديقةٌ غَلْباء، ملتفَّةٌ، وحدائقُ غُلْبٌ.
واغْلَوْلَبَ العشبُ: بلغ والتفّ. والغُلَبَّة بالضم وتشديد الباء: الغَلَبَة. قال المرّار:
أخذتُ بنجدٍ ما أخذتُ غُلُبّةً وبالغَوْرِ لي عِزٌّ أشمُّ طويلُ
ورجل غُلَبَّةٌ أيضاً: أي يَغْلِبُ سريعاً.
3- العين
غلب
غَلَبَ يغلِبُ غَلَباً وغَلَبةً.
والغِلابُ: النَّزاعُ.
والمُغَلَّبُ الذي يَغلِبُه أقرانه فيما يمارس.
والمُغَلَّبُ قد يكون المفضل على غيره.
والأَغْلَبُ: الغليظ الشديد القصرة واسد أَغْلَبُ.
وقد غَلِبَ غَلَباً، يكون من داء أَيضاً.
وهضبة غَلَباءُ، وعِزَّةٌ غَلْباءُ وتَغِلْبُ كانَتْ تسمى الغَلْباءَ
واغلَوْلَبَ العُشْبُ في الأرض إذا بَلَغَ كُلَّ مَبَلَغ.
4- المحكم والمحيط الأعظم
غلب
غَلبه يَغْلِبه غَلْباً وغَلَباً، وهي افصح، وغَلَبة، ومَغْلباً، ومَغْلَبة، قال أبو المثلَّم:
ريّاءُ مَرْقبةٍ مَنّاعُ مَغْلَبة رَكّاب سَلْهبة قَطاع أقران
وغُلُبَّى، وغِلبَّى، عن كراع، وغُلُبَّة، وغَلْبَّة، الأخيرة عن اللحياني: قهره.
وقالوا: أتذكر أيام الغُلُبَّة، والغُلُبَّى، والغِلبَّى؟ أي: أيام الغَلبة، ولم يقولوا: لمن الغَلَبُ،
والغَلَبة، ولم يقولوا: لمن الغَلْبُ.
ورجل غالب، من قوم غَلَبة، وغَلاّب، من قوم غلاّبين، ولا يكسر.
ورجل غُلْبة،و غَلُبّة: كثير الغلبة.
وقال اللَّحياني: شديد الغلبة.
وقال: لَتجدنّه غُلُبَة عن قليل، وغُلُبَّة، أي: غلاَّبا.
وغُلِّب الرجلُ: غَلَب.
وغُلِّب على صاحبه: حكم له عليه بالغَلبة، قال امرؤ القيس:
والغلب: غلظ العنف وعِظَمها.
وقيل: غلظها مع قِصَرٍ فيها.
وقيل: مع ميل، يكون ذلك من داءٍ أو غيره.
غَلِب غَلَباً، وهو اغلب.
وحكى اللحياني: ما كان اغلَب، وقد غَلب غلباً، يذهب إلى الانتقال عما كان عليه.
وقال يُوصف بذلك العُنق نفسه، فيقال: عُنق اغلب، كما قالوا: عُنق أجيد، وأوقص.
وقد يُستعمل ذلك في غير الحيوان، كقولهم: حديقة غلباء، أي: عظيمة متكاثفة، وفي
التنزيل: (و حَدائق غُلْبا)، قال الراجز:
أعطيت فيها طائعاً أو كارهاَ حديقةً غلباء في جِدارها
وأسد أغلب، وغُلُبُّ: غليظة الرقبة.
وهَضبة غلباء: عظيمة مشرفة.
وعزّة غَلْباء، كذلك، على المثل.
وقبيلة غلباء، عن اللَّحياني: عزيزة ممتنعة.
وقد غَلِبت غَلَباً.
واغلَولب النبت: بلغ كل مبلغ.
وخص اللِّحياني به العُشْب.
وحديقة مُغْلولبة: ملتفة.
وتَغِلب: قبيلة.
وبنو الغلباء: حي، قال:
واورثني بنو الغلباء مَجْداً حديثا بعد مَجدهِم القديم
وغالب، وغَلاب، وغُليب، أسماء.
وغَلاب: اسم امرأة من العرب، من العرب، منهم من يبينه على الكسر، ومنهم من يُجِريه
مجرى "زينب".
وغالب: موضع نخل دون مصر، قال كثير عزة:
5- المحيط في اللغة
غلب
غَلَبَ يَغْلِبُ غَلَبَةً وغَلَباً. والغِلابُ: النزَاعُ. واللهُ الغَلابُ.
وأسَد أغْلَبُ، والفِعْلُ غَلِبَ يَغْلَبُ غَلَباً-. والغلب: داءٌ.
وهَضْبَة غَلْبَاءُ. وعِزَّةٌ غَلْبَاءُ. وكانتْ تُسَمى تَغْلِبُ: الغَلْباءَ.
والغُلُبَى: الغالِبُ. ورَجُلٌ غُلُبةٌ: يَغْلِبُ سَرِيعاً. والغَلاَبِيَةُ: الغَلَبَةُ. والغُلْبَةُ: المغالَبَةُ..
واغْلَوْلَبَ العُشْبُ في الأرض: إذا بَلَغَ كُل مَبْلَغٍ. والنسبةُ إلى تَغْلِبَ: بالكَسْر والفَتْح. وبَعِيْرٌ غُلاب: الذي يَغْلِبُ بسَيْرِه. وقيل في قول الراجِزِ
يا لَيْتَ دَيْنَ غِلْبَتي قد حَلا
أتى وَقْتي الذي أغْلِب فيه الناسَ. وغَلابِ: اسْمُ امْرأةٍ.
6- تاج العروس من جواهر القاموس
غ-ل-ب
الغَلْبُ بفَتْح فَسُكُون ويُحرَّك، وَهِيَ أَفْصَح، والغَلَبَة مُحَرَّكة، والمَغْلَبَةُ بالفَتْح، وهو قَلِيل،
والمَغْلَبُ، بغيرِ هاءٍ، وهُمَا مَصْدَرَانِ مِيمِيَّان، وفي الأَوَّل قال أَبُو المُثَلَّم:
رَبَّاءُ مَرْقَبَةٍ، مَنَّاعُ مغْلَبَة رَكَّابُ سَلْهَبَة، قَطَّاعُ أَقْرَانِ
وفي المَغْلَبَةِ قالت هِنْدُ بنتُ عُتْبَةَ تَرْثِي أَخَاهَا:
يَدْفَعُ يومَ المَغْلَبَتْ يُطْعِم يوْمَ المَسْغَبَتْ
والغُلُبَّى كالكُفُرَّي، والغِلِبَّى كالزَّمِكَّي وَهُمَا عن الفَرَّاء، هكذا عِنْدنا في النُّسَخ المُصحَّحة،
فلا يُعَوَّل على قَوْل شَيْخِنا: لَوْ قَالَ كَذَا لأَجَاد، ثم قال: وربما وُجِد في نُسَخ، لكنه إِصْلاح،
والأُصُولُ المُصَحَّحة مُجَرّدة. قلت: وهذه دعوى عَصَبِيَّة من شيخنا، فإِنَّ النُّسخَ الَّتِي
رأَينَاها عَالِباً مَوْجودٌ فِيهَا هَذَا الضَّبْط، وإِذَا سَقَط من نُسْخَتِه لا يَعُمُّ السُّقُوطُ من الكُلِّ،
وكذا قولُه في أَوَّلِ المَادَّة: أَورد المُصَنِّفُ هذَا اللَّفْظَ وأَتْبَعَه بأَلْفَاظٍ غَيرِ مَضْبُوطة ولا مَشْهُورَة تبعاً لِمَا في المُحْكَم وذاك يتقيد لضبطها بالقَلم، وهذا الْتَزَم ضَبْطَ الأَلْفَاظ باللِّسَان، وكأَنَّه
نَسِيَ الشَّرط، وأَهْمَل الضَّبْط إِلى آخر مَا قَالَ. ولا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَه: ويُحَرَّك، ضَبْطٌ لِمَا
قَبْلَه، والَّذِي بَعْدَه مُسْتَغْنٍ عن الضَّبْط لاشْتِهَاره، واللّذانِ بَعْدَه من المَصَادِر المِيمِيَّة مَشْهُورَةُ
الضَّبْطِ لا يكاتد يُخْطِئُ فِيهِمَا الطَّالِب، واللَّذَانِ بعدَه فقد ضَبَطَهما بالأَوْزَان وإِن سَقط
من نُسْخَتِه، وضبَط الَّذِي بَعْدَه فقال: والغُلُبَّةُ بضَمَّتَيْنِ عن اللّحْيَانِيّ قال الشَّاعِرُ:
أَخذْتُ بِنَجْدٍ ما أَخَذْتُ عُلُبَّةً وبالغَوْرِ لي عِزٌّ أَشَمُّ طَوِيلُ
وَحَكَى اللِّحيانيّ: ما كانَ أَغْلَبَ، ولقد
غَلِبَ غَلَباً، يَذْهَب إِلى الانْتِقال عما كَان عليه. قال: وقد يُوصَف بذلِكَ العُنُق نَفسُه
فيقال: عُنقٌ أَغْلَبُ، كما يقال: عُنُقٌ أَجْيَدُ وَأْوْقَصُ وفي حديث ابن ذِي يَزَن:
بِيضٌ مَرَازِبَةٌ غُلْبٌ جَحَا جِحَةٌ
هي جمع أَغلب، وهو الغَليظُ الرَّقَبة وناقة غَلْبَاءُ: غَلِيظَةُ الرَّقَبَة: ومنه قولُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْر:
غَلباءُ وَجْنَاءُ عُلكومٌ مُذَكَّرَةٌ
7- تهذيب اللغة
غلب
قال الليث، يقال: غلب يغلب غلبة وغلباً، والغلاب: المغالبة، وأنشد بيت كعب إبن
مالك:
همَّتْ سخينةُ أن تُغَالِبَ ربِّها وليُغْلَبَنَّ مغالِبُ الغلاّب
وفي مثل للعرب: جرى المذكيات غلاب، أراد بالمذكيات مسان الخيل وقرحها، أراد أنها
تغلب من سابقها غلاباً لقوَّتها.
قال: والأغلب: الغليظ القصرة، أسد أغلب، وقد غلب يغلب غلباً، وقد يكون الغلب
من داء أيضاً.
قال: وهضبة غلباء وعزة غلباء، وكانت تغلب تسمى الغلباء.
وقال الشعر:
وأَوْرثَنِي بَنو الغلْبَاء مَجْداً حديثاً بعد مَجْدِهم القديم
وقال آخر:
وقَبْلَكَ ما أغْلَوْلَبَتْ تَغْلِبٌ بِغَلْباءً تَغلِب مُغْلَوْلِبينا
يعني بعزةٍ غلباء، وأغلولب العشب. وأغلولبت الأرض إذا إلتف عشبها، وأغلولب القوم
إذا كثروا، من أغليلاب العشب، ورجل غُلبة إذا كان غالباً، وغلبة لغة.
وأخبرني أبو محمد المزني عن أبي خليفة عن محمد بن سلام أنه قال: إذا قالت العرب:
شاعر مُغلب فهو مغلوب، وإذا قالوا غلب فلان، فهو غالب، وغلبت ليلى الأخيلية على
نابغة بني جعدة لأنها غلبته، وكان الجعدي مغلباً.
8- لسان العرب
غلب
غَلَبه يَغْلِبُه غَلْباً وغَلَباً، وهي أَفْصَحُ، وغَلَبةً ومَغْلَباً ومَغْلَبةً؛ قال أَبو المُثَلَّمِ:
رَبَّاءُ مَرْقَبةٍ، مَنَّاعُ مَغْلَبةٍ، رَكَّابُ سَلْهبةٍ، قَطَّاعُ أَقْرانِ
وغُلُبَّى وغِلِبَّى، عن كراع. وغُلُبَّةً وغَلُبَّةً، الأَخيرةُ عن اللحياني: قَهَره. والغُلُبَّة، بالضم
وتشديد الباءِ: الغَلَبةُ؛ قال المَرَّار:
أَخَذْتُ بنَجْدٍ ما أَخَذْتُ غُلُبَّةً، وبالغَوْرِ لي عِزٌّ أَشَمُّ طَويلُ
ورجل غُلُبَّة أَي يَغْلِبُ سَريعاً، عن الأَصمعي. وقالوا: أَتَذْكر أَيامَ الغُلُبَّةِ، والغُلُبَّى، والغِلِبَّى،
أَي أَيامَ الغَلَبة وأَيامَ من عَزَّ بَزَّ. وقالوا: لمنِ الغَلَبُ والغَلَبةُ؟ ولم يقولوا: لِمَنِ الغَلْبُ؟ وفي
التنزيل العزيز: وهم من بَعْدِ غَلَبِهم سَيَغْلِبُون؛ وهو من مصادر المضموم العين، مثل الطَّلَب.
قال الفراءُ: وهذا يُحْتَمَلُ أَن يكونَ غَلَبةً، فحذفت الهاءُ عند الإِضافة، كما قال الفَضْلُ بن
العباس بن عُتْبة اللِّهْبيّ:
إِنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فانْجَرَدُوا، وأَخْلَفُوكَ عِدَا الأَمْرِ الذي وَعَدُوا
أَراد عِدَةَ الأَمر، فحذف الهاءَ عند الإِضافة. وفي حديث ابن مسعود: ما اجْتَمَعَ حلالٌ
وحرامٌ إِلا غَلَبَ الحَرامُ الحَلالَ أَي إذا امْتَزَجَ الحرامُ بالحَلال، وتَعَذَّرَ تَمْييزهما كالماءِ والخمر
ونحو ذلك، صار الجميع حراماً. وفي الحديث: إِنَّ رَحْمَتي تَغْلِبُ غَضَبي؛ هو إِشارة إِلى
سعة الرحمة وشمولها الخَلْقَ، كما يُقال: غَلَبَ على فلان الكَرَمُ أَي هو أَكثر خصاله. وإِلا
فرحمةُ اللّه وغَضَبُه صفتانِ راجعتان إِلى إِرادته، للثواب والعِقاب، وصفاتُه لا تُوصَفُ بغَلَبَةِ
إِحداهما الأُخرى، وإِنما على سبيل المجاز للمبالغة.
ورجل غالِبٌ مِن قوم غَلَبةٍ، وغلاَّب من قوم غَلاَّبينَ، ولا يُكَسَّر.
ورجل غُلُبَّة وغَلُبَّة: غالِبٌ، كثير الغَلَبة، وقال اللحياني: شديد الغَلَبة. وقال: لَتَجِدَنَّه
غُلُبَّة عن قليل، وغَلُبَّةَ أَي غَلاَّباً. والمُغَلَّبُ: المَغْلُوبُ مِراراً. والمُغَلَّبُ من الشعراءِ: المحكوم
له بالغلبة على قِرْنه، كأَنه غَلَب عليه. وفي الحديث: أَهلُ الجنةِ الضُّعَفاءُ المُغَلَّبُونَ. المُغَلَّبُ:
الذي يُغْلَبُ كثيراً. وشاعر مُغَلَّبٌ أَي كثيراً ما يُغْلَبُ؛ والمُغَلَّبُ أَيضاً: الذي يُحْكَمُ له
بالغَلَبة، والمراد الأَوَّل.
وغُلِّبَ الرجلُ، فهو غالِبٌ: غَلَبَ، وهو من الأَضداد. وغُلِّبَ على صاحبه: حُكِمَ له
عليه بالغلَبة؛ قال امرؤُ القيس:
وإِنَّكَ لم يَفْخَرْ عليكَ كفاخِرٍ ضَعِيفٍ؛ ولم يَغْلِبْكَ مِثْلُ مُغَلَّبِ
وقد غالبَه مُغالبة وغِلاباً؛ والغِلابُ: المُغالَبة؛ وأَنشد بيت كعب بن مالك:
هَمَّتْ سَخِينَةُ أَن تُغالِبَ رَبَّها، ولَيُغْلَبَنَّ مُغالِبُ الغَلاَّبِ
والمَغْلبة: الغَلَبة؛ قالت هِنْدُ بنتُ عُتْبة تَرْثي أَباها:
يَدْفَعُ يومَ المَغْلَبَتْ، يُطْعِمُ يومَ المَسْغَبَتْ
وتَغَلَّبَ على بلد كذا: استولى عليه قَهْراً، وغَلَّبْتُه أَنا عليه تَغْليباً. محمدُ بنُ سَلاَّمٍ: إذا
قالت العرب: شاعر مُغَلَّبٌ، فهو مغلوب؛ وإِذا قالوا: غُلِّبَ فلانٌ، فهو غالب. ويقال:
غُلَّبَتْ ليْلى الأَخْيَليَّة على نابِغة بني جَعْدَة، لأَنها غَلَبَتْه، وكان الجَعْدِيُّ مُغَلَّباً.
وبعير غُلالِبٌ: يَغْلِبُ الإِبل بسَيْرِه، عن اللحياني. واسْتَغْلَبَ عليه الضحكُ: اشتدَّ،
كاسْتَغْرَبَ. والغَلَبُ: غِلَظُ العُنق وعِظَمُها؛ وقيل غِلَظُها مع قِصَرٍ فيها؛ وقيل: مع مَيَلٍ
يكون ذلك من داءٍ أَو غيره.
غَلِبَ غَلَباً، وهو أَغْلَبُ: غليظُ الرَّقَبة. وحكى اللحياني: ما كان أَغْلَبَ، ولقد غَلِبَ
غَلَباً، يَذْهَبُ إِلى الانتقال عما كان عليه.
قال: وقد يُوصَفُ بذلك العُنُق نفسه، فيقال: عُنُق أَغْلَبُ، كما يقال: عُنقٌ أَجْيَدُ وأَوْقَصُ.
وفي حديث ابن ذي يَزَنَ: بِيضٌ مَرازبةٌ غُلْبٌ جَحاجحة؛ هي جمع أَغْلَب، وهو الغليظ
الرَّقَبة، وهم يَصِفُون أَبداً السادةَ بغِلَظِ الرَّقبة وطُولِها؛ والأُنثى: غَلْباءُ؛ وفي قصيد كعب: غَلْباءُ وَجْناءُ عُلْكومٌ مُذَكَّرَةٌ. وقد يُسْتَعْمَل ذلك في غير الحيوان، كقولهم: حَديقةٌ غَلْباءُ أَي
عظيمةٌ مُتكاثفة مُلْتفَّة. وفي التنزيل العزيز: وحَدائِقَ غُلْباً. وقال الراجز:
أَعْطَيْت فيها طائِعاً، أَوكارِها، حَديقةً غَلْباءَ في جِدارِها
الأَزهري: الأَغْلَبُ الغَلِيظُ القَصَرَةِ. وأَسَدٌ أَغْلَبُ وغُلُبٌّ: غَلِيظُ الرَّقَبة. وهَضْبةٌ غَلْباءُ:
عَظِيمةٌ مُشْرِفة. وعِزَّةٌ غَلْباءُ كذلك، على المثل؛ وقال الشاعر:
وقَبْلَكَ ما اغْلَولَبَتْ تَغْلِبٌ، بغَلْباءَ تَغْلِبُ مُغْلَولِبينا
يعني بِعِزَّة غَلْباءَ. وقَبيلة غَلْباءُ، عن اللحياني: عَزيزةٌ ممتنعةٌ؛ وقد غَلِبَتْ غَلَباً.
واغْلَولَبَ النَّبْتُ: بَلَغَ كلَّ مَبْلَغٍ والتَفَّ، وخَصَّ اللحيانيُّ به العُشْبَ. واغْلَولَبَ العُشْبُ،
واغْلَولَبَتِ الأَرضُ إذا التَفَّ عُشْبُها. واغْلَولَبَ القومُ إذا كَثُرُوا، من اغْلِيلابِ العُشْبِ.
وحَديقَةٌ مُغْلَولِبَة: ملْتفّة. الأَخفش: في قوله عز وجل: وحدائقَ غُلْباً؛ قال: شجرة غَلْباءُ
إذا كانت غليظة؛ وقال امرؤُ القيس:
وشَبَّهْتُهُمْ في الآلِ، لمَّا تَحَمَّلُوا، حَدائِقَ غُلْباً، أَو سَفِيناً مُقَيَّرا
هذا ماستطعت الإتيان به ولعل الله أن يجعل فيه البيان الكافي